جمال القيسي : الثقافة .. بين التنظير الحكومي والانفصال عن الواقع
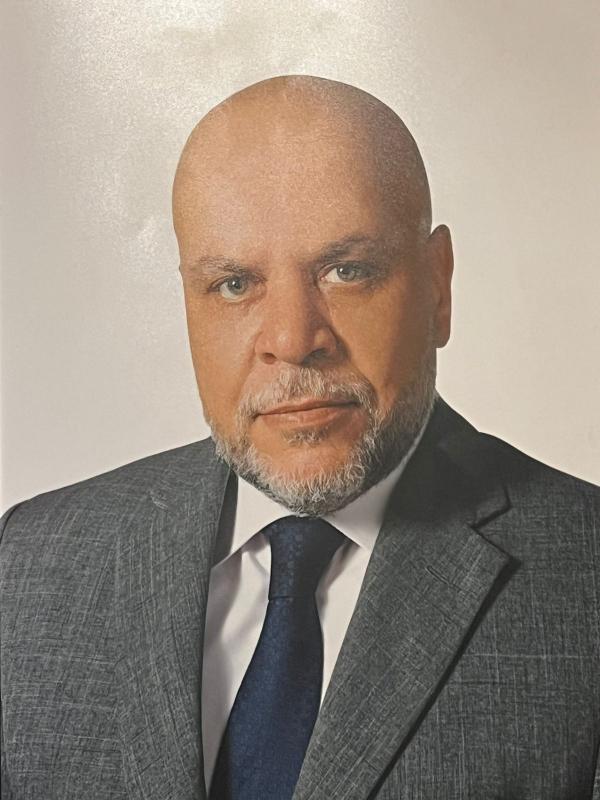
عند قراءة مضامين كتب التكليف السامي التي تحدد أولويات الدولة ثقافيا، نلاحظ حضورًا متكرّرًا في التركيز على قيم الانفتاح والتنوع الثقافي والهوية الأردنية الجامعة، بأبعادها العربية والإنسانية، والربط بين الثقافة والمعرفة والإبداع. هذا الحضور لا يأتي بوصفه ترفًا نخبويا، بل باعتباره جزءًا من رؤية نهضوية متكاملة، تدمج السياسي بالاجتماعي بالثقافي.
غير أنّ هذا الحضور الكثيف في النصوص لم يُقابل بحضور مماثل في السياسات أو الممارسات التنفيذية، بل ظلت الثقافة حبيسة (المناسبات الموسمية) ، وعنوانًا تتداوله الخُطب دون أن تحوّله المؤسّسات إلى آليات عمل أو بنى تغييرية؛ فما نعاينه في الواقع هو تكرار نمطي لأشكال ثقافية تقليدية، تبدأ بالمهرجانات وتنتهي عند حدود الفولكلور، دون أن تلامس الجوهر التحويلي للثقافة بوصفها أداة تفكيك وإعادة بناء.
ما نشهده حتى الآن في أداء الحكومات هو استمرار نمط موسمي من الأنشطة الثقافية، كاختيار مدينة ثقافية كل عام أو إطلاق أمسيات ومسابقات رمضانية وقرائية، دون أن يحدث ذلك اختراقًا حقيقيًا في تشكيل الوعي المجتمعي، أو في تجذير القيم العليا التي يُفترض أن تقوم عليها الثقافة. ففي دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عام 2023، تبين أن 76% من الشباب في المحافظات لم يشاركوا في أي نشاط ثقافي طوال السنة، في حين قال 62% منهم إنهم لا يعرفون دور وزارة الثقافة.
الثقافة لا يمكن أن تُختزل في الفولكلور والاحتفالات، ولا ينبغي لها أن تبقى أسيرة الفعل الموسمي؛ فالثقافة مشروع وعي وتنوير متكامل، يتطلب حضورًا دائمًا في الحياة اليومية، ومسؤولية كبرى في مواجهة قضايا مثل التطرف والانغلاق والانسحاب من الحياة العامة. بل إن أي انزلاق لجيل الشباب نحو التطرف أو المخدرات أو اللامبالاة السياسية، هو مؤشر على فشل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، في أداء دورها الوطني والتوعوي والتنويري.
وما يُفاقم من وطأة هذا الواقع، أنّ اللامبالاة الثقافية لم تعد مجرد عارض، بل باتت تُنتج فراغًا خطيرًا يُملأ بما هو نقيض للثقافة كالانغلاق والعنف والمخدرات والتطرّف؛ فحين يتقاعس الخطاب الثقافي عن الحضور في الفضاء العام، تتقدّم الظواهر الهامشية لتملأ الفجوة، متسلّحة بإغراءات آنية تُخدّر العقل وتُعطّل الإرادة.
وليس من المبالغة القول إن أي انزلاق لشبابنا نحو المخدّرات أو الإرهاب، هو في جزء كبير منه نتاج لانحسار الدور التنويري للدولة، وتراجع وظيفتها في رعاية الوعي وتحصين المجتمع.
فحسب تقرير إدارة مكافحة المخدرات لعام 2024، فإن نسبة التعاطي بين الفئة العمرية 18–30 عامًا ارتفعت بنسبة 27% خلال ثلاث سنوات فقط. كما تشير تقارير أمنية أخرى إلى أن معظم المتورطين في قضايا التطرف الفكري هم من الفئات غير المنخرطة في أي نشاط ثقافي أو حزبي.
أمام هذا المشهد، يبدو ضرورياً لا بل مُلحّاً، إعادة تعريف دور وزارة الثقافة؛ لا بوصفها دائرة مناسبات ومجاملات اجتماعية، بل كمختبر للأفكار، ومنصة استراتيجية تتقاطع فيها الثقافة مع التعليم، ومع الإعلام، ضمن مشروع الهوية الوطنية الجامعة. ولا يمكن لهذا الدور أن يتحقق إذا لم تُفسح المساحة، بكل احترام، أمام المثقفين الحقيقيين الفاعلين، أولئك الذين يمتلكون القدرة على التفكير النقدي، والجرأة على المراجعة، لا أولئك المكرّسين في حضرة السلطة والمألوف.
لقد آن الأوان أن تتحرّر الثقافة من منطق "الردّات الظرفية"، وأن تُبنى على أساس الفعل الاشتباكي المستمر مع قضايا الناس. وأن تنفتح على الشراكات الحقيقية مع رابطة الكتاب الأردنيين ونقابة الفنانين والأحزاب السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الرؤية والرسالة الوطنية المحضة؛ بوصفها الأذرع الطبيعية للمجال الثقافي، خصوصا الأحزاب؛ فالحزب السياسي، حين يكون حاملًا لرؤية، لا يكون مجرد أداة انتخابية، بل يتحوّل إلى رافعة ثقافية وفكرية، تعيد الاعتبار للسياسة كمجال للفعل المعرفي والنقدي.
إن الثقافة لا يمكن أن تزدهر في الظل، ولا يمكنها أن تُنتج وعيًا وهي معزولة عن نبض المجتمع. إنها صميم المشروع الوطني، ومكوّن أصيل في هندسة التحوّل الديمقراطي، ويجب أن تشارك في صياغته كلّ الأطراف: الدولة، والمجتمع، والأحزاب، والمثقف الفرد.
وإذا كان ثمة فجوة بين ما يُكتب في وثائق الدولة، وكتب التكليف السامي، وبين ما يُنفّذ على أرض الواقع، فإن هذه الفجوة لا يجوز أن تمر دون مراجعة شاملة وموضوعية، كونها حالة إخفاق تستحق التأمل وإعادة التأسيس.
من هنا، لا بد من إعادة تعريف دور وزارة الثقافة، لا كمؤسسة تنظيم فعاليات وأنشطة يمكن لأية جمعية ثقافية ناشئة تنفيذها؛ بل كخزان تفكير يدعم الاستراتيجية الوطنية، ويربط بين الثقافة والتعليم، ويكون شريكًا في مشروع الإصلاح السياسي والاجتماعي. الأمر الذي يستدعي الإشراك الحقيقي لطبقة المثقفين الفاعلين، لا أولئك المحسوبين على البيروقراطية الثقافية، في صياغة السياسات والتصورات.
المطلوب اليوم أن تتحول الثقافة إلى فعل اشتباكي مستمر مع قضايا المجتمع، وليس التعامل مع الثقافة على أنها مجرد نشاط مؤسسي روتيني، بل كأساس ثابت لبناء المجتمع والحفاظ على هويته وقيمه. وما لم تتحوّل السياسات الثقافية من مجرد شعارات إلى أدوات فعلية تلامس هموم الناس وتغذي تطلعاتهم، فإن الثقافة ستظل غائبة عن معركة التنمية والنهضة.
بعبارة موجزة؛ لن تكتمل الرؤية الوطنية الشاملة إلا إذا تبنّت الدولة والمجتمع معًا مسؤوليات جادة في تطوير الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي، ورؤية ديمقراطية تضمن التغيير الاجتماعي. ومن هنا، تبقى الثقافة على رأس الأولويات، والأمل في أن يتحول الخطاب الثقافي من مجرد خطاب تنظيري إلى فعل مستدام يساهم في إصلاح وتطوير المجتمع.







